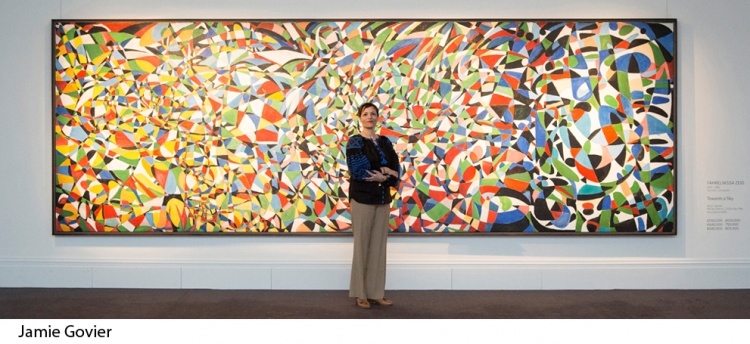فلسطين: لقاء مع الفاعلة الثقافية والكاتبة د. عادلة العايدي- هنية
Jan 2018ضمن خطة عمل المجموعة الوطنية للسياسات الثقافية في فلسطين للعام 2017، أجرت المجموعة الوطنية مجموعة من الحوارات مع فاعلين ثقافيين فلسطينيين في فلسطين التاريخية والشتات، تهدف هذا الحوارات ليس فقط إلى تسليط الضوء على الفاعلين الثقافيين وإسهاماتهم في مجال الثقافة والفنون، بل أيضاً الحصول على آرائهم فيما يتعلق ببعض القضايا ذات العلاقة والتي تؤثر على المشهد الثقافي الفلسطيني. سيتم نشر هذه الحوارات بالتتابع عبر موقع السياسات الثقافية في المنطقة العربية وضمن نشرته الالكترونية الشهرية.
د. عادلة العايدي-هنية
د. عادلة العايدي-هنية كاتبة وأكاديمية مختصة في الثقافة الفلسطينية والفكر العربي الحديث والفضاءات والممارسات الثقافية. شغلت د. عادلة منصب مديرة مركز خليل السكاكيني الثقافي لمدة 9 أعوام منذ 1996-2005 ووثّقت تجربتها في مقال مطوّل بعنوان "الفنون والهوية والبقاء: بناء الممارسات الثقافية في فلسطين 1996-2005" ونشر في مجلة الدراسات الفلسطينية. حيث كان للعايدي الدور الأكبر في تحويل مركز خليل السكاكيني الثقافي من مركز حكومي ناشئ ومجمّد إلى مركز ريادي ونشيط بعد تسجيله كمؤسسة أهلية. وكان له دور بارز في التأسيس لممارسات ثقافية مهمة رغم التحديات الكثيرة التي كانت تواجه المركز آنذاك والتي استطاعت العايدي تجاوز وتخطّي الكثير منها.
بعد 9 سنوات تفرّغت العايدي للعمل الأكاديمي والبحثي حيث نشرت في العام 2008 كتاب بعنوان "فلسطين. لا ينقصنا شيء هنا" تضمّن نصوصاً بالفرنسية وصوراً لأعمال فنية لمجموعة من الكتّاب والفنانين الفلسطينيين والعالميين حول فلسطين الثقافة والوجدان، ويُعدّ أول كتاب يبحث فلسطين المعاصرة من منطلق نقدي وحميمي. كما نشرت مؤخراً كتابها باللغة الإنجليزية "فخر النساء زيد؛ رسامة العوالم الباطنية" وهو تأريخ لسيرة الرسامة التركية الأردنية فخر النساء زيد (1901-1991) والتي علّمت العايدي الرسم في شبابها.
ونظراً لحرص العايدي على توثيق تجاربها ونشرها، يمكن للمهتمّ أن يجد الكثير من المواد المنشورة حول إنجازاتها، فقد تمّ التركيز في هذه المقابلة على آراء العايدي في عدد من القضايا.
حاورتها: صابرين عبد الرحمن
كجزائرية بدأت عملها في مجال الثقافة الفلسطينية بعد وصولك بأشهر قليلة إلى فلسطين، هل شعرت بنوع من الاغتراب؟
قبل استقراري في فلسطين كنت أعمل في فلسطين مع مؤسسة دولية فكنت آتي إلى فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس) بشكل دائم على مدى سنتين تقريباً، فلم أشعر بالغربة.
كان مركز خليل السكاكيني الثقافي من أوائل المراكز الثقافية التي عملت على خلق حالة ثقافية رسّخت لبناء ممارسات ثقافية في فلسطين، وواجه الكثير من التحديات في ذلك الحين -ربما ما زالت موجودة- لكنه استطاع تخطّي هذه التحديات في حينها، هل يمكن أن تُجملي لنا دورك في تخطّي هذه التحديات وما هي الظروف التي ساعدتك على تخطّي هذه الظروف؟
كان الهمّ الأساسي في ذلك الوقت للمركز والذي كان تابعاً لوزارة الثقافة تشغيل المركز بأسرع وقت، حيث كان عمل المركز مجمداً، فكانت الحاجة ماسّة إلى خبرة لإدارة المركز.
الأمر الثاني أن الناس كانت بعد انتهاء الانتفاضة بحاجة إلى متنفس وإلى إجابة على أسئلتها. كما لم يكن في حينها مراكز ثقافية مثل قصر الثقافة، كل هذا ساعد المركز أن يشكّل حالة في البلد. كما كانت البلد في تلك السنوات في جو جدّي أو ملتزم أكثر، أي قبل انتشار الثقافة النيوليبرالية الاستهلاكية المعولمة المرتبطة بطغيان السوشال ميديا وثقافة الترفيه التجاري وحياة المطاعم والمقاهي إلخ.
في تجربتك كمديرة لمركز خليل السكاكيني التي قمت بتوثيقها من خلال مقال مطوّل بعنوان "الفنون والهوية والبقاء: بناء الممارسات الثقافية في فلسطين 1996-2005" ونشر في مجلة الدراسات الفلسطينية، ذكرتِ أن العمل الثقافي في فلسطين ليس فقط لإغناء المجتمع ولكن كان أيضاً فعلاً مقاوماً، بعد أكثر من 10 سنوات على ذلك هل برأيك ما زالت الممارسات الثقافية في فلسطين فعلاً مقاوماً؟
الفكرة أكثر تعقيداً. من جهة من الممكن أن نثري حياة الناس المستفيدة من البرامج التي ننفذها من ناحية التحفيز على التفكير، طرح الأسئلة، فتح الآفاق وخلق تجارب وخلق الفرح. لكن هل هذا الفعل هو مقاومة؟ حتى مع الصبغة الوطنية للبرامج التي كنت أصيغها والتي كنا نقدمها في المركز، في النهاية حتى لو كانت فلسطين مستقلة يجب القيام بذات العمل. أظن أن هذه هي الخدمة الأساسية: فتح عوالم إيجابية فكرية ذهنية جمالية ثقافية عاطفية للجمهور، إضافة إلى التسلية والاستفادة.
ذكرتِ في مقالك أن عدد من المؤسسات المانحة في ذلك الوقت أدركت أن الثقافة في الحالة الفلسطينية "ذات بُعد تحرري"، هل باعتقادك أن هذه المؤسسات ما زالت متفهمة لهذ البعد بعد أكثر من 20 سنة على قدوم السلطة الفلسطينية وما رافق ذلك من تغيرات وضغوطات سياسية وغيرها؟
في مقالي كان حديثي أكثر عن أفراد في هذه المؤسسات المانحة. الشيء الآخر الذي أود التركيز عليه، أن الموضوع لم يتعلق فقط بجلب أموال المؤسسات الدولية، بل إضافة إلى ذلك هو تمكني من استقطاب دعم وتمويل من أفراد فلسطينيين ميسوري الحال في الداخل والشتات. وخصص جزء من دعمهم لتغطية المصاريف والنشاطات الجارية والجزء الأكبر خصص لتشكيل وقفية لاستثمارها بكل شفافية. آنذاك كانت كل قاعة وحتى الشجر في المركز يحمل أسماء المانحين لتكريمهم.
الحصول على منح من أفراد فلسطينيين يعطي مساحة للتصرف بحريّة أكبر. بالتأكيد من المهم الحصول على دعم من مؤسسات مانحة لتشغيل برامج المركز ولكن يجب الحصول على تمويل غير مشروط من أفراد، وهذا سر نجاح السكاكيني المالي في ذلك الوقت. بالتأكيد لم يكن هذا تمويلاً مفتوحا لكن كنا نتدبر أمورنا بالمبالغ الممنوحة.
استكمالاً لموضوع التمويل الفلسطيني للثقافة، هل ترين أن القطاع الخاص الفلسطيني حالياً له اهتمام حقيقي بالثقافة؟
الشركات في ذلك الوقت لم تكن تقدم منح لمركز السكاكيني لأنه لم يكن مركزاً جماهيرياً مثل المهرجانات الصيفية مثلا. لذلك كان التركيز على الأفراد.
سُمعة السكاكيني كانت ممتازة آنذاك ومتداولة في الإعلام العربي والدولي. كما كان يشكل مجلسه الإداري وهيئته العامة شخصيات ذات مصداقية عالية وسمعة جيدة. كما كان لدينا الحرص بعد الحصول على استقلاليتنا من السلطة على التنسيق مع الوزارات المعينة والتقيد بكافة القوانين المتعلقة بتنظيم عمل الهيئات غير الأهلية.
من جهة أخرى، لم تكن المسألة فقط نوعية البرامج التي يتم تنفيذها، بل التعامل مع المانحين باحترام بالتواصل معهم وتزويدهم بتقارير مالية وبرامجية باللغة العربية، إلخ. فكل هذا يولد ثقة لديهم. وبسبب سمعة مركز السكاكيني في ذلك الوقت وبسبب الشفافية كان من الممكن الحصول على منح خاصة. لكن حالياً أظن أن هؤلاء ربما يتوجهون لدعم مؤسسات ذات ديمومة مثل الجامعات، المتاحف، إلخ. وليس لمؤسسات تنقلب مجالس إداراتها بعد سنوات.
"بناء الجمهور" هي إحدى التحديات التي كانت تواجهكم في مركز خليل السكاكيني وقمتِ بذكرها في مقالتك وهو تحدٍ تواجهه الكثير من المؤسسات حيث تضعه وزارة الثقافة كأحد التحديات الرئيسية في خططها القطاعية حيث محدودية أو نخبوية المشاركة في الأنشطة الثقافية، برأيك ما المطلوب لجعل الثقافة والفنون مطلباً أساسياً للمواطن الفلسطيني؟
لو كنتُ أكبر سناً قبل استلامي إدارة المركز لأدركتُ هذا الموضوع. كنت أعتقد أنني وبمجرد استلامي لعملي وتحضير الخطة البرامجية وفتح المركز أن الناس ستنصبّ عليه. لكننا كنا نعيش في مجتمع واقع العلاقات الاجتماعية فيه والتشكيلات الحزبية والعائلية أهم مما يمكن تقديمه في جوهر أي نشاط. خاصة في تلك الفترة التي كانت رام الله فيه بلدة متوسطة الحجم خرجت للتو من أهوال قمع الإنتفاضة الأولى. بالتالي كان الخروج لحضور أية فعالية يخضع لاعتبارات مجتمعية وليس كما الآن. نحن حالياً في طور رام الله المدينة حيث لا تعرف الناس بعضها البعض، وهناك أناس من خارجها يعتبرونها مدينتهم. مع الوقت بدأت أدرك هذا الأمر، حيث كنت ألاحظ مثلاً عند تنظيم نشاط لشخص أو فرقة مشهورة يقبل الجمهور دون أي اعتبارات، وفي النشاطات ذات الطابع المحلي يقتصر الحضور على أبناء الحمولة أو الأصدقاء ورفاق الفصيل السياسي وبعض المهتمين الشغوفين بالثقافة. وعينا لهذه العوامل شيئاً فشيئاً مع زملائي الذين كانوا جلّهم مثلي من خارج رام الله. حالياً لاحظت كم رام الله كبرت ومع زيادة عدد السكان ونسبة التعليم يوجد جمهور أوسع ومنفتح، جمهور شبابي يقبل على الأنشطة الثقافية لأجلها أولاً قبل أو دون اعتبارات مجتمعية. ألاحظ هذا مثلاً في متحف محمود درويش؛ أكثر مؤسسة ناجحة في استقطاب جمهور محلي ومن فئات مجتمعية مختلفة. النقطة الثانية لها علاقة برومانسيات القطاع الثقافي على مر العصور وفي كل مكان؛ فنحن العاملين في هذا المجال نعتقد أن الثقافة يجب أن تكون للجميع؛ لكن الثقافة ليست كذلك. الثقافة لفئة أولاً متعلمة وثانياً لديها مستوى ثقافي. طبعاً يوجد فرق بين النشاط أو المنتج الثقافي أو الفني من جهة، وبين الذائقة أو الحس الجمالي وحب الاستطلاع الذين يمتلكهم كل إنسان. ثانياً، النشاطات الثقافية التي نتحدث عنها هي ظاهرة مدينية حيث يمكن التجمع في حفلة أو ندوة في مكان عام مع أشخاص لا تعرفهم لحضور نشاط لا تستفيد منه. إضافة، ما يساعد على الإقبال على هذه النشاطات هو الاعتياد منذ الصغر من خلال مرافقة الأهل أو مع الرحلات المدرسية. لذلك، يجب استهداف الأطفال بالأنشطة الفنية والثقافية مثل نوادي القراءة والسيرك والمخيمات الصيفية والأيام الترفيهية وطبعاً ضمن نشاطات مع المدارس الأمر الذي كنا سبّاقين له في السكاكيني. هناك أيضاً عامل سياسي واضح؛ حيث قرأت دراسات تربط علاقة وثيقة في أي مجتمع بين مستوى المشاركة المجتمعية-السياسية وبين الإقبال على النشاطات الثقافية والفنية؛ فإذا كان مستوى المشاركة عالياً تكون فيه نسبة المشاركة الثقافية عالية. في مجتمع يعاني من انسداد الأفق السياسي والاقتصادي يصعب الانفتاح على الشيء غير الضروري وغير المجدي مادياً. مع الخبرة والاطّلاع على تجارب الغير أدركتُ هذه العوامل، لكن في ذلك الوقت كان لدي اندفاع وحماس، ولو عاد الزمن لعملتُ بشكل مختلف. بالتالي لا أرى أنه يجب الشعور بالنقص في حال لم تأتِ الجماهير الغفيرة لحضور نشاطات ثقافية أو فنية. السؤال الذي يجب طرحه هو: كيف يمكن توسيع رقعة الجمهور المثقف نفسه؛ في حال كان الجمهور المثقف المحتمل 100 شخص وجاء 20 شخص هناك بالتأكيد مشكلة لكن في حال كان الجمهور المثقف 20 وجاء للنشاط 20 فلقد تحقق المطلوب. طبعاً الاستثناء لكل هذا كان معرض (100 شهيد – 100 حياة) سنة 2001-2003 ومعرض (لذكراهم) سنة 2003. شكّل المعرض حالة استثنائية من الإقبال الجماهيري من خارج فئة المثقفين والرواد المعتادين للمركز، لأنه توجّه للجرح العام والهم الوطني بأسلوب جديد من الاحترام لكرامة الإنسان الفلسطيني وتضحياته بعيداً عن الابتذال والرياء. طبعاً الأسلوب الفني المستعمل كان جديداً وينبع من أساليب فنية معاصرة وربما هذه الخلط في الأسلوب والجوهر حققا النجاح. طبعاً بعد هاتين التجربتين وددت في الاستمرار بابتداع هكذا مشاريع فنية وطنية ريادية ولكن كانت مسؤوليتي الأولى تجاه تحقيق الديمومة والاستمرارية المادية للمركز.
قطاع الفنون البصرية من أكثر القطاعات الفنية التي أوليتها اهتماماً أثناء عملك في مركز السكاكيني بسبب عدم الاهتمام -حسبما رأيتِ في ذلك الوقت- بهذا المجال، ما رأيك بمدى اهتمام المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بهذا القطاع حالياً؟
قطاع الفنون البصرية حالياً ليس بحاجة إلى مساعدة الجهات الرسمية، فقطاع الفنون البصرية أو الفنون المعاصرة أصبح النوع الفني الأول من خلال اجتذاب الدعم المالي الخاص والمؤسساتي في العالم، فنرى الكثير من الشباب الفلسطينيين من خلفيات مختلفة يتجه للعمل في الفنون البصرية لأن فرص التمويل والدراسة والشهرة متوفرة بسهولة وبسرعة. أصبح لدينا هيكلية تعليمية وسوق، لكن تبقى مشاكل دائمة تتعلق بغياب النقد مثلاً. القطاعات التي تحتاج إلى اهتمام تنموي حالياً هو قطاع الأدب والمسرح وذلك لرفع الجودة، وقطاع السينما لكي يخاطب الجمهور الفلسطيني أكثر.
بالعودة للحديث عن رام الله كمركز للأنشطة الثقافية في الضفة الغربية، هل تعتقدين أن توجّه المؤسسات الرسمية وغير الرسمية لكسر استقطاب رام الله للأنشطة حقق بعض النجاحات؟ وما رأيك بالحياة الثقافية في رام الله؟
عندما كنت أعمل في مركز السكاكيني، كانت إحدى الهموم لديّ نقل نشاطات المركز ليس فقط للمخيمات ولكن أيضاً خارج رام الله، وبداية وصولي عملت زيارات لنابلس وبيت لحم وغزة. الآن لدي وجهة نظر أخرى، لا يجب أن نلوم رام الله إذا كانت رام الله تعمل. بل علينا التشبيك والتعاون مع المؤسسات الشريكة والشبيهة.
أما نشر الثقافة للجميع فمن وظائف الدولة والمؤسسات التربوية العامة. مثلا معهد إدوارد سعيد الذي استطاع خلق حالة موسيقية في أكثر من مدينة وهذا شيء أكثر من رائع بفضل تركيزه على جوهر رسالته التعليمية.
الحياة الثقافية في رام الله بالمقارنة مع مدن كبيرة خارج فلسطين حياة غنية، لكن الشيء المفقود برأيي هو الديمومة ووجود برامج دورية. فالعديد من الإنتاجات الفنية –ما عدا المعارض الفنية-يتم عرضها لمرة واحدة وينتهي الأمر، هذا يخلق حالة أن الثقافة أمر استثنائي.
بعد أكثر من 20 سنة على تأسيس مركز خليل السكاكيني الثقافي وتأثيره على المشهد الثقافي في فلسطين كونه من أوائل المراكز الثقافية فيها، ومرور هيئات إدارية متعددة على إدارته، هل تعتبرين تجربة مركز خليل السكاكيني الثقافي هي تجربة تراكمية؟
بعد خروجي من المركز استمر العمل في المركز بذات الطريقة وتمّ البناء على ما كان موجوداً، وهذا كان شيئاً إيجابياً، وبعض المشاريع تم تحويلها إلى مشاريع فعلية، لكن بعدها بسنوات قليلة توقف الأمر. حالياً وبعد سنوات من الأفول يبدو أنه عاد المركز ليعمل بشكل مختلف ومركّز وبنجاح مع طاقم جديد من المتطوعين.
شعرت عادلة العايدي بعد عشر سنوات في مركز خليل السكاكيني الثقافي بالرغبة بالتحرر من كتابة المشاريع وإجراءات التمويل وغيرها وهي ذات الإشكاليات الموجودة حتى الآن، هل تعتقدين أننا في فلسطين تحوّلنا إلى آلات لجلب التمويل على حساب العمل الفكري والثقافي البحت؟
هذا مشكلة لكافة العاملين في القطاع الثقافي، لكن في النهاية هذا ما أُريد لنا كمجتمع فلسطيني أن نكونه. ليس فقط في القطاع الثقافي لكن في القطاع الصحي والزراعي، في المصارف وكافة المؤسسات. كلنا نعيش على المساعدات الخارجية وعلى القروض سواء السلطة والجمعيات الخيرية والمستشفيات، هذه البنية الاقتصادية للمجتمع، والقطاع الثقافي إذا كان معتمد على الدعم الخارجي ليس معناه أنه قطاع دخيل على المجتمع، ليس عندنا دولة أو وزارة ثقافة قادرة على الدعم.
في بعض الدول الوضع مختلف تماماً. في بلدان عربية ذات مركزية عالية مثلاً، نجد أن القطاع الثقافي يقدم مشاريع تمويل ولكن لوزارة الثقافة أو للقصر الملكي. في أوروبا مثلاً، الأقاليم والبلديات لها ميزانيات دعم للمؤسسات الثقافية خدمةً للجمهور الدافع للضريبة بالخدمات الثقافية، وفوقهم أيضاً الدولة المركزية ثم الشركات والمؤسسات الخاصة. المشكلة لدينا أنه لا توجد هذه الأطر، بالتالي هناك اعتماد شبه تام على المانح الخارجي.
عملت كثيراً على نقل القضية الفلسطينية والثقافة الفلسطينية للخارج من خلال الكثير من الأنشطة والمشاركات ونشر الكتب مثل كتاب "فلسطين.. لا ينقصنا شيء هنا" بالفرنسية عام 2008، حدثينا بداية عن هذا الكتاب وأهميته؟ وهل ترين أن من واجب المثقف من خلال عمله الثقافي والبحثي والأكاديمي نقل قضاياه للعالم؟
كانت فكرتي أن نخرج هذا الكتاب، دعوت الناس للكتابة وحررت النصوص وكتبت مقدمته، كان هناك موسم ثقافي فلسطيني في بلجيكا، كنت عضو في لجنة الإشراف على تنظيم الموسم. كل عضو كان متخصص بملف معين، وكنت مسؤولة عن ملف الحوارات والمنشورات، اقترحت نشر كتاب حول ماذا تعني فلسطين للفنان والمثقف الفلسطيني المعاصر سواء من فلسطين والخارج، وجدنا دار نشر واشتغلت معهم مباشرة حيث وضعت القائمة المدعوة وتم دعوة المساهمين، كان هذا عمل شبه تطوعي رمزي وخرج الكتاب للنور، وهو كتاب مهم، وأخذت عنوانه من عنوان قصيدة لهلا الشروف، الكتاب باللغة الفرنسية، أشخاص كثيرون قدموا لنا نصوص منهم محمود درويش حيث قدّم لنا قصائد جديدة له ، وأيضاً محمود شقير وعايشة عودة وغيرهم، الكتاب يعطي صورة عن فلسطين في ذلك الوقت.
ولكن نحن لسنا سفراء، أولاً يجب أن نهتم بأنفسنا قبل العالم، المثقف يعبر عن نفسه ويفكر ويخاطب المجتمع، في حال العالم اهتم بالموضوع فهذا جيد، لكن أعتقد أنه يجب أن نلتفت لمجتمعنا فهذا أكثر أهمية.
كيف يمكن لعمل الخبراء والمتخصصين والمطلعين والباحثين أن لا يكون منعزلاً عن العمل الثقافي الذي تتبناه المؤسسة الرسمية؟ وبرأيك هل تلجأ المؤسسة الرسمية لهؤلاء الأشخاص؟
المجتمع الفلسطيني مجتمع قوي وعانى تاريخياً من غياب السلطة المركزية أو ضعفها، بالتالي المجتمع الفلسطيني وعكس مجتمعات عربية متكلة على الدولة، نجح في الداخل والخارج في تطوير مؤسساته التجارية والعلمية والمجتمعية والثقافية ويعتمد على ذاته. إن كتب لهذه المؤسسات الاستدامة أم لا فهذا موضوع آخر. المجتمع الفلسطيني على مر العقود غني بأفراد نذروا أفسهم للقضية والمجتمع وقاموا بعمل لا تعمله المؤسسة الرسمية، وكثير منهم كانوا من النساء.
أنت كنت من المؤسسين لمؤسسات إقليمية هامة مثل الصندوق العربي للثقافة والفنون ومؤسسة المورد الثقافي، كيف استطاعت هذه المؤسسات التأسيس لممارسات ثقافية عربية وما هي ملامح هذه الممارسات؟
الفائدة واضحة، هذه المؤسسات هي مصدر غير أجنبي وغير حكومي للمثقف والفنان ليلجأ له ويفهم مشاكله واهتماماته دون ضغوطات سياسية من قبل الدولة أو من قبل القطاع التجاري أو المؤسسات المانحة، المشاريع التي يتم تمويلها أو دعمها أو إخراجها للوجود كان مستحيل أن يقوم بإخراجها إطار حكومي أو تجاري أو أجنبي، هاتان مؤسستان مهمتان لا بد من وجودهما، وهما تخلقان جيل عربي كامل يساعدهما على إخراج أنشطتهم وهذا شيء مثري للمجتمع.
آخر إنجازات عادلة العايدي هو كتاب حول سيرة الفنانة التركية الأردنية فخر النساء زيد بعنوان "فخر النساء زيد: رسامة العوالم الباطنية"، حدّثينا عن هذا الكتاب وأهميته؟
الشيء المفيد أنه لا يوجد لدينا توثيق لحيوات الفنانين العرب، ليس فقط عن أين ولد وتوفي وغيره بل عن حياته وعن عمله وصراعاته الشخصية والفنية سواء كان أديباً أو فناناً. استمرّ العمل 9 أشهر من العمل المكثّف حيث حصلت على منحة من الصندوق العربي للثقافة والفنون ومن مؤسسة بريطانية لدعم الكتّاب حيث دار النشر إنجليزية. اشتغلتُ بالأرشيف الخاص بها للحصول على المادة الخام حيث كانت تكتب كل شيء عن حياتها وتحتفظ بكل شيء ينشر عنها، وبعد تجميع هذه المادة من أرشيفها بحثتُ في تاريخ الفن والتاريخ للربط وعمل إضاءات.
بالعودة للحديث عن أدوار النساء في مجتمعنا، هل ترين أن النساء أكثر انخراطاً في الحياة الثقافية والفكرية في فلسطين؟ وهل الممارسات للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية تعزز هذا الإنخراط وإبراز أدوار النساء؟
في كل الدول يطغى وجود النساء على القطاع الثقافي، لأن هذا القطاع لا ينافسنا عليه الرجال، بالتالي من الممكن أن نجد أنفسنا به بسهولة.